في جغرافية مصر الاجتماعية – من كتاب شخصية مصر ودراسة في عبقرية المكان
للكاتب الدكتور جمال حمدان
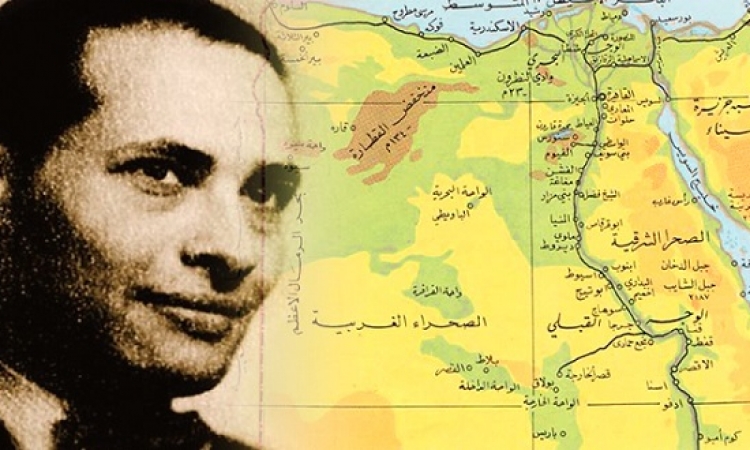

من النظريات البيئية الشائعة في الدراسات الاجتماعية نظرية تربط بين الطغيان السياسي وبين البيئة النهرية، والنظرية قديمة إلى حد كبير، على الأقل تسبق “مونتسكيو” الذي أطلق سلسلة ضخمة من علاقات الربط بين الظاهرات الطبيعية والظاهرات البشرية عموما، ولكنها لقيت رواجا وذيوعا خاصين في القرن التاسع عشر، ولم تزل تعيش في كثير من المذاهب والمراجع حتى يومنا هذا بصورة محددة أو مجددة.
فمن قبل في أواخر القرن الماضي لاحظ الاقتصاديون الكلاسيكيون والاشتراكيون على حد سواء أن ثمة في العالم مجموعة من البلاد تعيش على الأنهار، المجتمعات النهرية وزراعة الري، تشترك في ملامح اجتماعية وسياسية تختلف بها عن مجتمعات “الزراعة المطرية” وتصل إلى قمتها في النهاية في الطغيان، فسماها الكلاسيكيون «المجتمع الآسيوي» أو ما يطلق عليه: أسلوب الإنتاج الشرقي mode deproduction asitiaque بينما تعذر على الاشتراكيين إدخالها في برنامج التطور الطبقي الماركسي وسموها «بالأسلوب الآسيوي أو الشرقي للإنتاج، وفى كل الحالات صك «الطغيان أو الاستبداد الشرقي oriental despotism كتعبير متداول يركز تلك العلاقة.
الطبيعة النهرية
وفى أول هذا القرن عاد ماتويتزي Matteuzzi إلى النظرية ولخصها في أن الظروف الجغرافية الطبيعية في مصر القديمة والعراق وأشور وفارس وفينيقيا واليونان وروما مسئولة عن نوع التنظيم السياسي الذي نشأ بها، فالأربعة الأولى سادها الحكم المطلق، والثلاثة الأخيرة سادها الحكم غير المطلق، ثم أرجع الحكم المطلق فى مصر والعراق إلى الطبيعة النهرية وزراعة الري، بينما ردها في فارس إلى الطبيعة الجبلية، ومن السهل – كما لاحظ سوروكين- أن تنقد آراء ماتويتزي، أولاً في تحديد طبيعة الحكم السياسي المفترض، ثم ثانياً في الربط مع البيئة الطبيعية حيث رد التنظيم السياسي الواحد إلى أكثر من بيئة طبيعية واحدة(1).
وفى خمسينيات هذا القرن عاد “كارل فيتفوجل” إلى النظرية من زاوية أخرى هي زاوية التفسير الاقتصادي الماركسي للتاريخ، أو بالأحرى أعاد التعبير عنها، فاختبرها وطبقها على البيئات النهرية في مصر والعراق وفارس والصين والهند إلى جانب حضارات العالم الجديد القديمة، وذلك في كتاب يقرأ من عنوانه «الاستبداد» الشرقي، دراسة مقارنة في الحكم المطلق»(٢).
وسواء عند ماتويتزي أو من سابقوه، أو عند فيتفوجل أو من يمثلهم(٢)، فالنموذج المثالي للنظرية هو مصر دائماً، ومصر القديمة بالدقة، وفى القرن الماضي، قرن الاستعمار، أثار الكثيرون ممن كتبوا عن مصر هذه النظرية بتحديد مباشر، ولهذا لابد من التصدي لها ولمغزاها وللنتائج التي ترتب عليها أو تخرج منها، وفى هذه المناقشة لابد من التمييز بين جانبين أو قضيتين في النظرية: الظاهرة الاجتماعية السياسية فى حد ذاتها، ثم العلاقة الايكولوچية (أي البيئية) المفترضة بينها وبين الظاهرة الطبيعية، وفى الحالين يتعرض الباحث الموضوعي بالضرورة لآراء قد تبدو أو قد تكون افتراءات على مصر والمصريين، ولكننا – وهذه نقطة حيوية بقدر ما هي بديهية – نذكرها لا لنرددها، بل لنرد عليها، ونُشرحها لنشرحها، وفى النهاية لكى نحدد موقعها من العلم وموقفنا العلمي منها، وبغير هذا قد يساء الفهم، خاصة من جانب السطحيين أو الأدعياء، وبالأخص “الديماجوجبين” والمتشنجين.

إيكولوجية النيل الاجتماعية والمجتمع الهيدرولوجي
ولنبدأ بالحقائق الطبيعية غير الخلافية أو الجدلية الحقيقة الكبرى فى كيان مصر هي أنها بيئة فيضية لا تعتمد على المطر الطبيعي فى حياتها وإنما على ماء النهر، وقوامها هو زراعة الري، الري الصناعي، لا الزراعة المطرية، ومن هنا بالدقة يبدأ كل الفرق في حياة المجتمع النهري وطبيعته، ففي البلاد التي تعيش على الأمطار مباشرة يختزل المجهود البشرى إلى حده الأدنى، فبعد قليل من إعداد الأرض والبذر يتوقف العمل أو يكاد حتى الحصاد، وبين هذا وذاك فليس هناك من يحفر الترع والمصارف أو يقيم الجسور والسدود، وأهم من هذا كله أن ليس هناك من يمكنه أن يحبس عنك المطر أو أن يتحكم في توزيعه.
حقاً إن الزراعة المطرية عرضة لذبذبات المناخ، وفلاحها من ثم تحت رحمة الطبيعة، لكنك لست بحاجة -ولن تستطيع أن أردت، وهذا هو المهم – أن «تخطط» المطر، من هنا فقد تكون الطبيعة سيدة الفلاح، ولكن الفلاح بعد ذلك سيد نفسه، وهذا في نفس الوقت يمنح الفلاح فرصة للفردية بدرجة أو بأخرى.
أما في بيئة الري فالأمر مختلف كل الاختلاف، فالوادي في فجر تاريخه ليس مصرفاً طبيعياً ولكنه مستنقع إسفنجي ملاري مشبع، ولا زراعة ولا تعمير إلا بعد التصريف الأمر الذي يتطلب مجهود بشرى جماعي ضخم حتى تعد الأرض “مجرد إعداد” لاستقبال البذرة، وبعد هذا فلا بذر حتى توصل المياه إلى الحقول، أي لابد من شبكة غطائية كثيفة من الترع من كل مقياس ابتداء من قنوات الحمل وقنوات التغذية إلى مساقي الحقول، حتى تزرع إذن لابد لك أولاً من أن تعيد خلق الطبيعة، ثم ما جدوى تلك الشبكة إذا لم تسيطر على أعناقها ورؤسها بالنواظم والقناطر والسدود؟ أعنى أى جدوى فيها بغير «ضبط النهر»؟
وأكثر من هذا، ما جدوى الجميع بغير «ضبط الناس»؟ أن زراعة الرى إذا تركت بلا ضابط يمكن أن تضع مصالح الناس المائية في مواجهة بعضها البعض مواجهة متعارضة دموية، ذلك أن كل من يقيم على أعلى الماء يستطيع أن يسيء استعماله أما بالإسراف أو بحبسه تماماً عمن يقع أسفله، أي أن كل حوض علوي يستطيع أن يتحكم في حياة – أو موت- كل حوض سفلى، وكل من يقع على أفواه الترع يستطيع أن يهدد حقوق المياه لمن يقع على نهايات الترع، كذلك يمكن للمحاباة والتحيز أن تسخو بالماء لمن تريد وتقبضه عمن تريد، إن العلاقات المائية داخل الوادي بأكمله، أشبه ما تكون بقانون الأواني المستطرقة، كل تغيير فيها هنا يستتبعه بالضرورة تغيير هناك، وأى مضخة كابسة هنا هي بمثابة مضخة ماصة هناك.

ضرورة العدالة المائية
المحصلة إذن واضحة، بغير ضبط النهر يتحول “النيل النبيل” إلى شلال حطام جارف، وبغير ضبط الناس يتحول توزيع الماء إلى عملية دموية، ويسيطر على الحقول قانون الغاب والأدغال، ولو تركت البيئة المصرية غابة اجتماعية لما تطورت عن الغاب الطبيعي الذي بدأت منه، والواقع أن البيئة الفيضية يمكن أن تجعل من «المجتمع الهيدرولوجي» – كما يسميه “برون” – مجموعة من المصالح المتعارضة، فتصبح سلسلة الأحواض سلسلة من المتنافسين، ومما له مغزاه أن كلمة منافس فى اللاتينية مشتقة من كلمة نهر rivalus, rivus ولعلها ليست صدفة كذلك أن المصريين القدماء اشتهروا بكثرة الخصام والتقاضي، وفيما بعد بالأخذ بالثأر.
وكمجرد مثال من القرن الماضي، كان رفاعة الطهطاوي (الذي قد يعد أبا الجغرافيا الحديثة أو من آبائها في مصر) على وعى كامل بضرورة الوحدة المائية، فهو يذكر عصر المماليك فيربط بين تفككه السياسي (السناجق) وبين تضاربه المائي «.. فكان في أيامهم لكل قسم وكل قرية ترع وجسور خصوصية لا ينتفع من السقي منها إلا أهاليها ولم يكن بينهم روابط عمومية، فكان أصحاب الأراضي والمزارعون لها المجاورون شطوط الماء يحتكرون الري والسقي ويختلسون من المياه ما هو قريب منهم ويمنعون الأراضي البعيدة من ذلك مع كونها لها حق فى مشاركتهم في المياه عند الفيضان.. فكان ينشأ من هذا ما لا مزيد عليه من عداوة قرية لأخرى، وربما ترتب على ذلك القتال وسفك الدماء».
التنظيم الاجتماعي شرط الحياة السليمة
في ظل هذا الإطار الطبيعي يصبح التنظيم الاجتماعي شرطاً أساسياً للحياة، ويتحتم على الجميع أن يتنازل طواعية عن كثير من حريته ليخضع لسلطة أعلى توزع العدل و”الماء” بين الجميع، سلطة عامة أقوى بكثير مما يمكن أن تتطلبه بيئة لا تعتمد على نهر فيضي في حياتها ومصيرها، وبذلك لا تكون الطبيعة وحدها سيدة الفلاح، وإنما بين الإثنين يضيف الري سيداً آخر هو “الحاكم”، هنا يصبح الحكم والحاكم «وسيطا» بين الإنسان والبيئة أو وصيا على العلاقة بينهما وهمزة الوصل بين الفلاح والنهر، أي أن الحكومة -فكرة وجهازا- هي بالضرورة أداة التكامل الإيكولوجي بين البيئة والإنسان، إنها تبدأ نتيجة وضرورة جغرافية، لتنهى «عاملا جغرافياً» بكل معنى الكلمة.
المجتمع الهيدرولوجي النموذجي
ومن تلك العناصر جميعاً يتألف في النهاية المجتمع الهيدرولوچي النموذجي الذي تنسج خيوطه من ثلاثية: الماء، والفلاح، والحكومة -والأخيرة طرف في المعادلة لا يقل أصالة وضرورة وحتمية عن الطرفين الآخرين، بل إننا لنستطيع أن نذهب إلي حد القول بأن أصل وظيفة الحاكم والحكم في المجتمع الهيدرولوچي على وجه التحديد إنما هي وظيفة وزارة الأشغال والري أكثر منها وزارة الزراعة بعامة، وأن أساس الملك فيه هو وظيفة «محكمة المياه» water court أو كما وضعها رفاعة الطهطاوى «العدل أساس العمران».
وإذا كانت تلك هي ضرورات وطبيعة البيئة النهرية والري من الداخل، فينبغي ألا نغفل عاملاً هاماً خارجياً من حولها، فالبيئة الفيضية، كواحة صحراوية، معرضة لأطماع وغارات الرعاة البدو باستمرار، وهذا فى ذاته يستدعى تنظيماً سياسياً قوياً متماسكاً في الداخل، وهو وحده جدير بأن يعطى للحكومة سلطة قوية، ولقد رأينا كم هو حافل سجل الغزوات والغارات الرعوية على مصر طوال التاريخ، وكيف كان بقاؤها يتوقف على الدفاع الخارجي بقدر ما كان يتوقف على الضبط النهري في الداخل.
ملامح المجتمع الهيدرولوجي
فإذا ما التفتنا إلى مصر القديمة بصورتها الفرعونية، فستجابهنا هذه الملامح، ملامح المجتمع الهيدرولوچي، إلى حد نادر المثال.. فقد وضع فرعون ضلعاً أساسياً في مثلث الإنتاج إلى جانب الضلعين الطبيعيين الماء والشمس وأصبحت “العبقرية” الضلع الثالث في مثلث الحضارة إلى جانب الضلعين الآخرين الحاجة الإمكانية، وليس صدفة بعد هذا أن كلاً من هذه الأطراف الثلاثة قد عبد وآله، فمن ناحية كانت الديانة والميثولوچيا المصرية القديمة تعطى مكاناً بارزاً لكل من النيل (حابى) والشمس (رع) كآلهة، بينما -للمقارنة الدالة- لم يكن للرياح الشمالية أو القمر أهمية ذات بال.
ومن ناحية أخرى، إذا كان فرعون قد تحول إلى الملك – الإله، فذلك أساساً بصفته “ضابط النهر”، بصفته الملك – المهندس، وبصفته بطريقة ما «صانع المطر» البعيد، بل يرى البعض، على أساس أن ضبط النهر كان بداية كل شيء- أن حكومة مصر الفرعونية كانت في معنى حكومة الفنيين، أي “التكنوقراط”.
ولم يكن غريباً بعد ذلك أن العقد الاجتماعي، كما يقول “سايس”، كان قائماً على الماء: «أعطني أرضك وجهدك، أعطك أنا مياهي» ومثل هذا العقد لا يمكن أن يتصور أو أن يقوم في ظل زراعة المطر.

الحقائق الطبيعية
وها هنا يكمن الفارق الجوهري بين زراعة الري وزراعة المطر، فالحكومة في ظل الأخيرة لا غنى عنها حقاً، ولكن في أبعاد وحدود أضيق بكثير منها في زراعة الري، فوظائفها هناك أقل، وليست بحاسمة بالضرورة، وفى النتيجة فإن سلطانها ونفوذها لا يتضخم إلى هذا المدى الذي تمكن له زراعة الري، ونحن قد نستطيع أن نتصور بيئة زراعة المطر بلا حكومة لحين ما، أو لأحيان، دون أن تنهار فيها الحياة كلية وبالضرورة، ولكنا نعجز تماماً عن أن نتصور المجتمع الهيدرولوچي “مجتمعاً أناركيا” أو فوضوياً دون أن يتهدد كيانه في ذاته وصميمه.
من أول وأبرز من أدركوا هذه الحقائق الطبيعية وعبروا عنها بدقة علمية، كان نابليون «لا توجد في بلد حكومة ذات أثر في رخاء الأهالي» كتب هو يقول في مذكراته بالمنفى “”Memorial St Helene بالقوة التي في يد حاكم مصر، فهنا، إذا أحسنت الحكومة قيادتها، جرى الماء في قنوات أعتني بحفرها وصيانتها، روعيت العدالة في توزيع مياهها، تبعاً لقواعد مرصودة، غطى الفيضان مساحات أوسع، أما إذا ساءت الإدارة الحكومية، بسبب فسادها أو ضعفها، سد الطمي القنوات، بينما تتهرأ السدود المقامة بالإهمال عندما لا تراعى قواعد المناوبات نتيجة للقلاقل أو تغلب الأغراض الخاصة للأفراد والجماعات، فليس الأمر في مصر كما هو عندنا، حيث ينعدم أثر الحكومة على سقوط المطر أو الجليد في ضياع المحصول أو نفوق الماشية».
كذلك ومرة أخرى نجد إدراكاً ثاقباً لهذا الوضع عند الطهطاوي، ربما متأثراً ب “كلود بك” عندما كتب يقول: «إن خصب مصر ويمنها» متسبب عن النيل، ويمن محصولها الزراعي متسبب عن اختلاف الفصول والأمطار، فبهذا كانت مصر مستعدة لكسب السعادة أكثر من غيرها بشرط انتظام حكومتها واجتهاد أهاليها، لأن اختلال حكومتها يخل بمزارعها، بخلاف اختلاف غيرها من الحكومات، فلا يؤثر شيئاً في جريان الفصول والأمطار» ثم يمضى إلى الحكومة المركزية كالنتيجة المنطقية والشرطية فيقول: «فلابد من صورة تنظيمية وأصول اجتماعية مستوفية للمذاهب المائية وقوة إجرائية، ومثل هذا لا يكون من وظيفة الآحاد والأفراد، ولا من محض وظيفة القرى والبنادر والبلاد سواء كان بالاجتماع والانفراد بل هذه وظيفة القوة الحاكمة العمومية..
فنفوذ الحكومة هو الذي يتعهد إصلاح هذه الدرة اليتيمة.. ولما كان ري مصر دائماً صناعياً مدبراً كان لابد فيه من حسن الإدارة المائية والضبط والربط في تطهير الترع وبناء الجسور والقناطر.. فإذا كانت الحكومة المتولية على مصر سيئة التدبير تجحف بالمصلحة العمومية، وهذا الخلل إنما يترتب على عدم قيام الحكومة المركزية بدورها.




